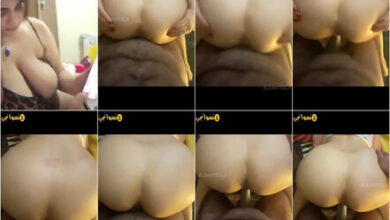ثقافة – عرش المحروسة: قصة الصعود المذهل لمحمد علي باشا – سكس جديد 2026
عرش المحروسة: الصعود المذهل لمحمد علي باشا
في تاريخ الأمم، يظهر رجال كأنهم قُدّوا من صخر العزيمة، رجال لا يكتفون بقراءة التاريخ، بل يصرّون على كتابته. واحد من هؤلاء، وبلا شك، هو محمد علي باشا؛ الرجل الذي بدأ حياته تاجراً بسيطاً في بلدة مقدونية مغمورة، وأنهاها مؤسساً لسلالة حكمت مصر لأكثر من قرن ونصف، وبانياً لنهضتها الحديثة.
قصته ليست مجرد سرد لأحداث، بل هي ملحمة من الذكاء العسكري، والدهاء السياسي، والطموح الذي لا يعرف حدوداً.
الفصل الأول: التبغ والبارود (النشأة والبدايات)
في عام 1769 (أو 1770 حسب بعض الروايات)، وُلد الصغير في بلدة “قولة” الساحلية في مقدونيا (اليونان حالياً)، التي كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. كان هذا الطفل هو محمد علي. لم يكن دمه ملكياً؛ بل كان والده، إبراهيم آغا، قائداً محلياً صغيراً، وعمل هو نفسه في شبابه في تجارة التبغ.
لم يكن في نشأته ما يوحي بأنه سيصبح “والي مصر” أو “عزيزها”، ولكن القدر كان يخبئ له دوراً آخر. عندما قرر السلطان العثماني إرسال حملة لاستعادة مصر من أيدي الفرنسيين (بعد حملة نابليون بونابرت)، انضم محمد علي إلى الكتيبة الألبانية كمعاون لرئيسها (ابن عمه).
كانت هذه هي اللحظة التي التقى فيها البارود بالتبغ. هبط محمد علي على شواطئ الإسكندرية عام 1801، ولم يكن يعلم أنه لن يغادر هذه الأرض أبداً.
الفصل الثاني: ساحة الفوضى (الوصول إلى مصر)
وجد محمد علي مصر كـ “بركان سياسي” جاهز للانفجار. الفرنسيون ينسحبون، المماليك (الطبقة الحاكمة القديمة) يريدون استعادة نفوذهم، العثمانيون (الأتراك) يريدون فرض سيطرتهم، والإنجليز يراقبون المشهد بطمع.
هنا، برزت عبقرية محمد علي الحقيقية. لم يكن الأقوى عسكرياً، لكنه كان الأذكى سياسياً.
* كسب الشعب: في خضم الفوضى والضرائب الباهظة التي فرضها الولاة العثمانيون، انحاز محمد علي بذكاء إلى الشعب المصري وزعمائه، خاصة علماء الأزهر الشريف وشخصية مثل “عمر مكرم”.
* اللعب على التناقضات: تحالف مع المماليك ضد الوالي العثماني، ثم انقلب على المماليك بدعم من الشعب، ثم تخلص من منافسيه داخل فرقته الألبانية. كان يلعب الشطرنج بينما كان الآخرون يلعبون “الطاولة”.
بلغت الفوضى ذروتها عام 1805. فاجتمع زعماء الشعب في “دار المحكمة”، واتخذوا قراراً تاريخياً: عزل الوالي العثماني خورشيد باشا، وتعيين “محمد علي” والياً على مصر. كان هذا حدثاً فريداً؛ فلأول مرة، يختار الشعب حاكمه بنفسه. رضخ السلطان العثماني في إسطنبول للأمر الواقع.
الفصل الثالث: تثبيت العرش بالدم (مذبحة القلعة)
لم يكن العرش مريحاً. الإنجليز حاولوا احتلال مصر (حملة فريزر 1807) لكنهم هُزموا في رشيد. والتهديد الأكبر كان لا يزال كامناً في الداخل: المماليك.
كان محمد علي يعلم أنه لا يمكن بناء دولة حديثة بوجود قوة عسكرية موازية لا تدين له بالولاء. فدبّر واحدة من أكثر الخطط دموية ومكراً في التاريخ.
في 1 مارس 1811، دعا محمد علي كبار أمراء المماليك إلى حفل فخم في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، احتفالاً بتقليد ابنه “طوسون” قيادة الجيش الذاهب إلى الحجاز. جاء المماليك بكامل زينتهم وخيولهم.
بعد انتهاء الاحتفال، وعندما كان الموكب يمر عبر ممر صخري ضيق (درب الميزر)، أُغلقت الأبواب فجأة من الأمام والخلف. وانهال الرصاص من كل جانب. كانت مجزرة مروّعة. لم ينجُ منهم إلا القليل.
كانت “مذبحة القلعة” لحظة قاسية، لكنها كانت أيضاً اللحظة التي أصبح فيها محمد علي السيد الأوحد لمصر بلا منازع.
الفصل الرابع: المهندس (بناء مصر الحديثة)
بمجرد أن استتب له الأمر، بدأ محمد علي مشروعه الأضخم: تحويل مصر من ولاية عثمانية متأخرة إلى دولة قوية على الطراز الأوروبي. لم يكن يريد “إصلاحاً”، بل أراد “إعادة خلق” للدولة.
1. الجيش أولاً (الجيش والبحرية)
كان يؤمن أن “الجيش هو الدولة”. استدعى ضباطاً أوروبيين (أشهرهم الكولونيل سيف، الذي أسلم وسُمي “سليمان باشا الفرنساوي”) لتدريب أول جيش مصري حديث قائم على التجنيد الإجباري للفلاحين المصريين. ولأول مرة، أصبح الجيش “مصرياً” بعد قرون. كما بنى ترسانة في الإسكندرية لبناء أسطول بحري جبار.
2. شريان الحياة (الاقتصاد والزراعة)
* الاحتكار: طبق نظام “الاحتكار”، حيث أصبحت الدولة هي المشتري الوحيد للمحاصيل والمنتج الوحيد للصناعات.
* القطن: أدخل زراعة القطن طويل التيلة، الذي أصبح “ذهب مصر الأبيض” ومصدر ثرائها.
* البنية التحتية: شق الترع (أهمها المحمودية) وأصلح القناطر، لضمان الري طوال العام.
3. العقل والآلة (التعليم والصناعة)
* البعثات: أرسل مئات الطلاب المصريين للدراسة في أوروبا (خاصة فرنسا)، وكان منهم “رفاعة الطهطاوي” رائد التنوير.
* المدارس: أنشأ مدارس متخصصة لم تكن موجودة من قبل (الطب في قصر العيني، الهندسة “المهندسخانة”، الألسن).
* التصنيع: بنى مصانع للنسيج، السكر، الأسلحة، والبارود. كان يريد “مصر تصنع كل شيء بنفسها”.
الفصل الخامس: حلم الإمبراطورية (التوسع العسكري)
لم يكن طموح محمد علي يقف عند حدود مصر. لقد رأى نفسه “نابليون الشرق”.
* الحرب في الجزيرة العربية (1811-1818): أرسل جيوشه (بقيادة أبنائه طوسون وإبراهيم) للقضاء على الدولة السعودية الأولى (الحركة الوهابية) بناءً على طلب السلطان العثماني. ونجح في ذلك.
* غزو السودان (1820-1822): أرسل ابنه “إسماعيل” لضم السودان، بحثاً عن الذهب والرجال (لتجنيدهم).
* حرب اليونان (1824-1828): مرة أخرى، استنجد به السلطان لإخماد الثورة اليونانية. أرسل ابنه “إبراهيم باشا” وأسطوله. كاد أن ينجح، لولا تدخل القوى الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، روسيا) التي دمرت الأسطول المصري العثماني في معركة نافارين (1827).
كانت “ناڤارين” صفعة قوية. حيث شعر محمد علي أنه ضحى بأسطوله من أجل سلطان لا يستحق. ومن هنا، بدأت فكرة “الانفصال” تتبلور.
الفصل السادس: الصدام الكبير (الحرب ضد السلطان)
هذا هو ذروة الدراما. محمد علي يطالب السلطان العثماني بولاية “سوريا” كمكافأة له عن خسائره في اليونان. والسلطان يرفض.
في عام 1831، أعطى محمد علي الضوء الأخضر لابنه العبقري “إبراهيم باشا”.
انطلق الجيش المصري كالسهم. سقطت عكا، دمشق، حلب. لم يكن الجيش العثماني نداً للجيش المصري الحديث. واصل إبراهيم زحفه، وعبر جبال طوروس، ودخل الأناضول (قلب تركيا).
في معركة قونية (1832)، سحق إبراهيم باشا الجيش العثماني وأسر قائده الأعلى (الصدر الأعظم). أصبح الطريق إلى “إسطنبول” (عاصمة الخلافة) مفتوحاً!
كانت الإمبراطورية العثمانية على وشك الانهيار على يد “خادمها” السابق.
الفصل السابع: خيانة القوى العظمى (النهاية القسرية)
هنا، تدخل “الكبار”. بريطانيا وروسيا والنمسا لم تكن لتقبل بظهور إمبراطورية جديدة قوية في الشرق بقيادة رجل طموح كمحمد علي.
لماذا تدخلوا؟ خافوا على “توازن القوى”. بريطانيا تحديداً خشيت على طريقها إلى الهند.
معاهدة لندن (1840): اجتمعت القوى الكبرى (باستثناء فرنسا، حليفة محمد علي) وفرضت عليه شروطاً مذلة:
* الانسحاب الفوري من سوريا وكريت والجزيرة العربية.
* تخفيض حجم الجيش المصري إلى 18,000 جندي فقط (بعد أن كان مئات الآلاف).
* تفكيك أسطوله.
* إلغاء نظام الاحتكار (وهذا دمر الصناعة المصرية الناشئة).
رفض محمد علي في البداية. فضرب الأسطول البريطاني شواطئ بيروت وعكا. ومع تخلي فرنسا عنه، اضطر للقبول.
لقد تحطم حلم الإمبراطورية. لكنه حصل على “جائزة ترضية” واحدة، كانت هي الأهم للمستقبل: تثبيت حكم مصر والسودان في أسرته “وراثياً”.
الفصل الثامن: غروب الأسد (السنوات الأخيرة والرحيل)
كانت معاهدة لندن بمثابة “نهاية” لمحمد علي الطموح. لقد كُسرت إرادته. بدأ الرجل الذي حكم بالحديد والنار يتدهور صحياً وعقلياً.
أصابه الضعف والوهن (يُعتقد أنه خرف الشيخوخة أو ألزهايمر). أصبح غير قادر على إدارة شؤون الدولة.
في عام 1848، تم تشكيل مجلس وصاية ثم نُقلت السلطة فعلياً لابنه العظيم “إبراهيم باشا”.
المفارقة المؤلمة أن إبراهيم نفسه كان مريضاً، وتوفي بعد أشهر قليلة من توليه الحكم (في حياة أبيه).
في 2 أغسطس 1849، في قصر رأس التين بالإسكندرية، أسلم “أسد قولة” الروح. توفي محمد علي باشا عن عمر يناهز 80 عاماً. ويُقال إنه حتى لحظة وفاته، لم يكن يعلم بوفاة ابنه إبراهيم.
دُفن في مسجده المهيب الذي بناه في قلعة القاهرة، المكان الذي شهد يوماً تثبيت سلطته بالدم.
الخاتمة: الإرث الخالد
مات محمد علي، لكن مشروعه غيّر وجه مصر إلى الأبد. هو شخصية جدلية بلا شك؛ كان حاكماً مستبداً، استخدم السخرة وفرض ضرائب باهظة، وسحق معارضيه بلا رحمة.
لكنه في الوقت نفسه، كان المؤسس. هو الذي سحب مصر من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، وبنى جيشها، وأسس تعليمها، ووضع أسس دولتها المركزية القوية التي استمرت حتى قيام ثورة 1952. لقد ترك إرثاً لا يمكن محوه، وقصة تلهم العقول عن كيف يمكن للطموح البشري أن يغير مجرى التاريخ.