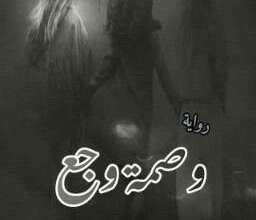متسلسلة – القوس والعذراء – حتى الفصل التاسع – أفلام سكس مصري محارم جديد

أنا الابن الوحيد لأبي وأمي، ذلك الطفل الذي جاء إلى الوجود في ظروف غريبة، كأنها حكاية من روايات الأقدار. أمي، تلك الفتاة الرقيقة التي لم تكد تتجاوز أعتاب الطفولة، حبلت بي وهي في الثانية عشرة من عمرها. كانت **** تحمل طفلاً، وكأن الزمن قرر أن يعجّل بخطواتها نحو الأمومة قبل أن تكتمل خطواتها كفتاة. واليوم، وقد بلغت الثامنة عشرة، أجد نفسي أقف على مشارف العشرين، بينما أمي، التي أصبحت في الثلاثين، لا تزال تحتفظ بشبابها الذي يخطف الأنفاس، كأن الزمن توقف عندها، أو ربما قرر أن يتسامح معها ويمنحها فرصة لتعيش ما فاتها.
كانت أمي، في عيني، أكثر من مجرد أم. كانت كأخت كبرى، صديقة، ورفيقة درب. الفارق العمري الضئيل بيننا جعل علاقتنا تتشابك بطريقة غريبة، كأننا ننتمي إلى عالمين: عالم الأمومة التقليدي، وعالم آخر أكثر قربًا وتفردًا. كنت أراها وهي تضحك، فأشعر أن الضحكة تنتمي إلى فتاة في مثل عمري، لا إلى امرأة حملت مسؤولية تربية *** وهي لا تزال تبحث عن ذاتها. كانت تشبه مديحة يسري في شبابها، تلك الممثلة التي كانت تجمع بين الرقة والقوة، بين الجمال الآسر والروح الحرة. عيناها، تلك العينان اللتين كانتا تخفيان أسرارًا لم أستطع يومًا فك شيفرتها، كانتا تعكسان قصة حياة لم تُروَ بعد.
كنت أحبها، ولكن حبي لها لم يكن كحب أي ابن لأمه. كان هناك شيء آخر، شعور عميق ومعقد يتجاوز حدود العلاقة الأسرية. كان حبًا رومانسيًا، كأن قلبي، الذي لم يتعلم بعد كيف يميز بين الحب العائلي والعاطفة الجياشة، قد وقع في حيرة. كنت أجد نفسي أراقبها وهي تمشط شعرها الطويل أمام المرآة، أو وهي تقرأ كتابًا في ضوء المصباح الخافت، فأشعر بشيء يعتصر قلبي. كنت أعلم أن هذا الشعور محرم، أنه خط أحمر لا يجب تجاوزه، ولكن كيف لي أن أتحكم في قلبي وهو يرى فيها المرأة قبل الأم؟
كانت أمي تدرك شيئًا من هذا الصراع الداخلي، أو هكذا ظننت. كانت تنظر إلي أحيانًا بنظرات تحمل خليطًا من الحنان والحذر، كأنها تخشى أن تقترب أكثر مما ينبغي، أو أن تبتعد فتتركني في وحدتي. كنا نتحدث لساعات طويلة، عن أحلامها التي لم تتحقق، عن طفولتها التي سُرقت منها، وعن أيامي أنا في المدرسة وأحلامي التي بدأت تتشكل. كانت تستمع إلي باهتمام، وكنت أشعر أنها ترى فيّ جزءًا من شبابها الضائع، أو ربما كنت أنا مرآتها التي تعكس ما كان يمكن أن تكونه.
كان أبي، ذلك الرجل الغامض الذي لم أعرفه جيدًا، غائبًا عن حياتنا معظم الوقت. كان يظهر بين الحين والآخر، يحمل معه بعض الهدايا أو القصص، ثم يختفي مجددًا. لم أكن أحمل ضغينة تجاهه، لكنني لم أشعر يومًا أنه جزء من عالمي الصغير الذي كونته أنا وأمي. كانت هي عالمي بأكمله، وكنت أعلم أنني، بطريقة ما، أصبحت عالمها هي الأخرى.
في تلك السنوات، بدأت ألاحظ التغيرات في أمي. كانت تحاول استعادة جزء من حياتها، كأنها أفاقت من حلم طويل. بدأت تقرأ المزيد، وتتعلم أشياء جديدة، وتتحدث عن أحلامها بلهفة لم أرها من قبل. كانت تريد أن تصبح شيئًا أكثر من مجرد أم، وكنت أشجعها، رغم أنني كنت أشعر بغصة في قلبي كلما فكرت أنها قد تبتعد عني يومًا ما. كنت أخاف أن أفقدها، ليس كأم، بل كتلك الفتاة التي رأيتها في عينيها، تلك التي تشبهني وأشبهها.
هكذا كانت حياتنا، مزيجًا من الحب والحيرة، القرب والبعد، الحلم والواقع. كنت أعيش في ظلال تلك العلاقة الفريدة، أحاول أن أفهم نفسي وأفهمها، وأتساءل إلى أين ستقودنا الأيام. كنت أعلم أن هذا الفصل من حياتي لن يكون عاديًا، وأن القادم سيحمل المزيد من التعقيد والجمال، كما تحمل دائمًا قصص الحياة الحقيقية.
الفصل الثاني: رقصة الحدود
كان تاريخ ميلادها في الثالث من ديسمبر، نفس اليوم الذي وُلدت فيه مديحة يسري، تلك الممثلة التي كانت أمي تعكس صورتها كما تعكس المرآة الضوء. كانت تشبهها بشكل مذهل: عيناها العميقتان، وجهها الناعم الذي يحمل مزيجًا من البراءة والجاذبية، شعرها الطويل الناعم كالحرير الذي يتدفق كشلال، وقوامها الرشيق الذي يوحي بأن الزمن لم يمسها. أما أنا، فقد وُلدت في الخامس عشر من سبتمبر، تحت سماء خريفية هادئة، كأن القدر أراد أن يفصل بيننا بفصول السنة، لكنه لم يستطع أن يفصل بين قلوبنا.
كنت أجد متعتي في لحظات العناية بها، كأنني فنان يرسم لوحة لا تكتمل إلا بتفاصيلها. كنت كثيرًا ما أجلس بجانبها، أحمل زجاجة طلاء الأظافر الأحمر القاني، وأطلي أظافرها بعناية، أراقب كيف يتحول كل ظفر إلى جوهرة صغيرة تلمع تحت ضوء المصباح. كنت أمشط شعرها الطويل، أمرر أصابعي بين خصلاته بحذر، كأنني أخاف أن أزعج سحر تلك اللحظة. ثم كنت آخذ أحمر الشفاه، ذلك الروج الأحمر الذي يبرز جمال شفتيها، وأضعه بعناية، وأنا أحبس أنفاسي. كنت أضيف لمسات من بودرة الخدود على وجنتيها، وأرسم الكحل حول عينيها ليبرز عمقهما، وأضع ظلال الجفون التي تجعلها تبدو كأنها نجمة سينمائية من زمن مضى.
كنت أحب أن أزينها، كما لو كنت ألبس دمية ثمينة أو أعيد تشكيل تمثال فني. كنت أساعدها في ارتداء أساورها الفضية التي كانت ترن بلحن خفيف مع كل حركة، وأضع خلخالها الرفيع حول كاحلها، وأتأمل جمال قدميها الصغيرتين. كنت أختار لها قلادتها بعناية، وأضع أقراطها التي تتأرجح بلطف عندما تضحك. كانت تلك اللحظات طقوسًا خاصة بيننا، لحظات تجمع بين القرب والجمال، بين الحب والتردد.
لكن قلبي كان يدفعني أحيانًا إلى ما هو أبعد من ذلك. كنت أجد نفسي أقترب منها، أضمها بحنان، أقبل وجنتها وأشعر بدفء بشرتها تحت شفتيّ. كنت أحيانًا أحاول، بدافع غريزي لا أفهمه تمامًا، أن أقبل شفتيها، لكنها كانت تمنعني بلطف، بنظرة تجمع بين الحب والحزم. كانت يدها تربت على كتفي، أو تدفعني برفق، كأنها تقول: “هناك حدود لا يجب أن نعبرها”. كنت أحيانًا أترك يدي تتجول، ألمس نهديها الكبيرين من فوق ثوبها، أو أمرر أصابعي على ساقها الناعمة أو قدمها، لكنها كانت تمنعني بنفس اللطف، كأنها تحميني من نفسي، أو ربما تحمي نفسها من شيء لا تستطيع أن تفهمه.
كانت تلك اللحظات مزيجًا من الإحساس بالذنب والرغبة، من الشوق والخوف. كنت أعلم أن مشاعري ليست كما ينبغي أن تكون، لكنني لم أستطع مقاومة سحرها. كانت أمي، ولكنها كانت أيضًا تلك المرأة التي أراها في أحلامي، التي أشعر أنني أنتمي إليها بطريقة لا أستطيع تفسيرها. كانت تبتسم لي، وفي ابتسامتها كنت أرى عالمًا من الأسرار، عالمًا أردت أن أكتشفه ولكنني كنت أخاف منه في الوقت ذاته.
كانت أمي تعيش حياتها بين دور الأم وروح الفتاة التي لم تكتمل. كانت تحاول أن تجد توازنًا بين مسؤولياتها تجاهي وبين رغبتها في استعادة جزء من شبابها. وأنا، في خضم مشاعري المضطربة، كنت أحاول أن أجد مكاني في هذا العالم الذي كنا نشاركه سويًا. كنت أعلم أن هذه الرقصة بين القرب والبعد، بين الحب والحظر، لن تستمر إلى الأبد. كان عليّ أن أجد طريقة لفهم مشاعري، ولها أن تجد طريقة لتعيش حياتها دون أن تفقد نفسها أو تفقدني.
الفصل الثالث: جذور الحكاية
كان القدر يخطط للقاءٍ لم يكن أحدٌ يتوقعه، في قرية صغيرة على ضفاف النيل، حيث تتسلل رائحة البرتقال والياسمين إلى كل زاوية. كان أبي، شابًا في السابعة عشرة من عمره، طالبًا في السنة الثانية ثانوية، يتمتع بوسامة هادئة وروح متمردة تخفيها ابتسامة خجولة. كان يُدعى حسن، وكان يعمل في أوقات فراغه في ورشة والده لتصليح الدراجات، يمسح العرق عن جبينه ويحلم بمستقبل أكبر من حدود القرية.
أما أمي، نور، فكانت فتاة في الثانية عشرة، لا تزال في الصف الثاني الإعدادي، تتمايل في زيها المدرسي الأبيض والأزرق، شعرها مربوط بشريطة حمراء تتناغم مع خدودها الوردية. كانت نور تُشبه مديحة يسري في عينيها الكبيرتين اللتين تحملان براءة الطفولة وغموضًا مبكرًا، وجهها المستدير الناعم، وشعرها الطويل الأسود الذي كان يصل إلى خصرها. كانت تمشي إلى المدرسة كل صباح مع صديقاتها، تضحك بصوت يشبه رنين الأجراس، وتحلم بأن تصبح معلمة يومًا ما.
التقيا لأول مرة في سوق الجمعة، حيث كان حسن يبيع قطع غيار دراجات بجانب والده، وكانت نور تمر مع والدتها لشراء خضروات. كانت نور تحمل سلة صغيرة، وعيناها تلتقطان كل شيء بفضول. توقفت أمام بسطة حسن لتشتري برتقالة، فسألها مازحًا:
«هل تحبين البرتقال الحلو، يا صغيرة؟»
ردت نور بخجل، لكن عينيها لمعت:
«أحب الحلو، لكن أمي تقول إن الحلو يكلف كثيرًا».
ابتسم حسن، وأعطاها برتقالتين بدل واحدة، قائلاً:
«هدية مني، لأجمل زبونة في السوق».
كانت تلك اللحظة بداية خيط رفيع من التواصل. بدأ حسن ينتظرها كل جمعة، يحتفظ لها بأجمل البرتقال، ويتبادلان النظرات والكلمات القصيرة. كانت نور تشعر بشيء جديد في قلبها، شيء يشبه الفراشات، لكنها لم تفهمه. أما حسن، فقد وقع في غرام تلك الفتاة الصغيرة التي تجمع بين البراءة والجمال، وكان يرى فيها عالمًا يريد أن يحميه.
مع مرور الأسابيع، بدأ حسن يمر بجانب مدرسة نور الإعدادية، ينتظرها عند الخروج. كانا يتجولان معًا على كورنيش النيل، يتحدثان عن أحلامهما. كانت نور تخبره عن دروسها، وعن كيف تحب الرسم والشعر، وكان حسن يحكي لها عن حلمه بامتلاك ورشة كبيرة في المدينة. كانا يضحكان، ويتقاسمان حلمًا بريئًا، لكن عيني حسن كانتا تحملان رغبة أكبر من مجرد الصداقة.
في إحدى الليالي الصيفية، حيث كان القمر يضيء النيل كمرآة فضية، تهورا. كانا يجلسان على ضفة النهر، بعيدًا عن أعين القرية. كانت نور ترتدي فستانًا قطنيًا خفيفًا، وكان حسن يمسك يدها بحذر. تحدثا عن الحب، عن الأفلام التي رأياها، وعن قبلات الأبطال على الشاشة. ثم، في لحظة من الجنون، اقترب حسن وقبلها. كانت قبلة أولى لكليهما، خرقاء، مليئة بالرهبة والرغبة. لم يتوقفا. في تلك اللحظة، تحت ضوء القمر، عبرا خطًا لم يكن من المفترض أن يعبراه. كانت نور خائفة، لكنها شعرت بشيء قوي يجذبها إلى حسن. كان الأمر بالنسبة لهما كأنه حلم، لكنه كان أيضًا بداية كارثة.
بعد شهر، بدأت نور تشعر بتغيرات في جسدها. كانت تشعر بالغثيان صباحًا، وتتعب بسرعة. كانت خائفة، لكنها لم تجرؤ على إخبار أحد. أخيرًا، أخبرت والدتها، التي اصطحبتها إلى طبيب نسائي في المدينة المجاورة. عندما أخبر الطبيب والديها أن نور حامل، كان الصمت يخيم على الغرفة. كانت والدتها تبكي، ووالدها، رجل صلب، يمسك رأسه بيدين مرتجفتين. أما نور، فقد شعرت أن العالم انهار فوق رأسها. كانت ****، لا تعرف شيئًا عن الأمومة، وكانت خائفة من المستقبل.
عندما علم حسن بالأمر، لم يتردد. ذهب إلى منزل نور فورًا، وقف أمام والدها، وقال بصوت مرتجف لكنه حازم:
«أنا أحب نور، وسأتزوجها. سأتحمل مسؤوليتي».
كان والد نور غاضبًا في البداية، لكنه رأى في عيني حسن صدقًا وإصرارًا. بعد نقاشات عائلية طويلة، وافقا على الزواج، بشرط أن يستمر حسن في عمله وأن تكمل نور دراستها.
تزوجا في حفل بسيط، حضره الأهل والأصدقاء المقربون. كانت نور ترتدي فستانًا أبيض بسيطًا، وكانت عيناها مليئتان بالدموع، مزيجًا من الخوف والأمل. حملت نور طوال تسعة أشهر، وكانت والدتها ترعاها كأنها **** أخرى. في ليلة الولادة، أنجبت نور طفلاً، أنا. كانت الولادة صعبة بسبب صغر سنها، لكنها نجت، ووضعت طفلها بين ذراعيها، تنظر إليه بعينين لا تصدقان أن هذا الطفل خرج منها.
رغم كل شيء، سمح والدا نور لها باستكمال دراستها. كانت والدتها تتكفل برعايتي أنا، الرضيع، بينما كانت نور تذهب إلى المدرسة الإعدادية، ثم الثانوية. كانت تدرس ليلاً، وتعود لترضعني، ثم تنام ساعات قليلة. كان حسن يعمل في الورشة، يوفر المال للعائلة، وكان يحاول أن يكون زوجًا وأبًا رغم صغر سنه. عندما بلغت نور الثامنة عشرة، التحقت بالجامعة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية. كانت تدرس، وترعاني، وتحلم بمستقبل أفضل. تخرجت وهي في الثانية والعشرين، بمساعدة والديها اللذين كانا يرعيانني كأنني ابنهما.
كانت نور قد تحولت من فتاة إلى امرأة، لكنها احتفظت بجمالها وروحها الحرة. أما حسن، فقد بدأ يغيب تدريجيًا، يترك نور تواجه الحياة وحدها مع طفلها. لكن تلك قصة أخرى، قصة سأرويها يومًا ما.
الفصل الرابع: عشر سنوات من الضوء
كنتُ في العاشرة من عمري حين سلّمت جدتي — بعد قبلة طويلة على جبيني — يدي إلى أمي وقالت لها بصوت يختلط فيه الارتياح بالحزن:
«خلاص يا نور، كبرتِ الآن، وكبر ابنك معكِ. البيت بيتكم، والمسؤولية مسؤوليتكم».
كانت أمي في الثانية والعشرين، تخرجت لتوّها من كلية الآداب بتقدير جيد جدًا، وكأن السنوات العشر الماضية كانت جسرًا طويلًا عبرته من الطفولة إلى الأمومة الكاملة. حملت حقيبتي المدرسية الصغيرة، وأمسكت بيدي، ومشينا معًا إلى البيت الجديد — شقة صغيرة في الدور الثالث من عمارة متواضعة في حيّ الدقي — وكأننا نبدأ حياة جديدة لا يعرفها أحد سوى أنا وهي.
أول يوم كأم كاملة
في اليوم الأول، استيقظتُ على رائحة الفطائر بالجبنة والزعتر. دخلت المطبخ فوجدتها ترتدي مريلة مطبخ وردية، شعرها مربوط بذيل حصان مرتفع، وهي تغنّي بصوت خافت أغنية فيروز: «يا أنا يا أنا…». وضعت الصحن أمامي، ثم جلست قبالتي، تُطعمني بيدها كأنني لا أزال رضيعًا. قالت:
«من اليوم، أنا اللي هأكلك، هلبّسك، هذاكر معاك، وهلعب معاك. محدش هياخد مكاني تاني».
كانت عيناها تلمعان بفرحة لم أرها من قبل، فرحة الأم التي استعادت ابنها بعد سنوات من الانتظار.
الدلال اليومي
كانت تدللني بطريقة تجعلني أشعر أنني أمير في قصر صغير:
- كل صباح، تختار لي الملابس بنفسها — قميص أزرق مع بنطال جينز، أو تيشرت مكتوب عليه «سوبرمان» — ثم تقف أمامي، تمسك كتفيّ، وتتأملني كأنها ترسم لوحة.
- في المساء، كانت تجلس بجانبي على الأريكة، تضع رأسي على فخذها، وتمشّط شعري بأصابعها وهي تقرأ لي قصصًا من مجلة «ميكي». كنتُ أغفو وأنا أسمع صوتها يروي مغامرات «بطوط» و«الأخوين دال».
- كل جمعة، كانت تأخذني إلى مكتبة «مدبولي» في طلعت حرب، وتتركني أختار ثلاث مجلات: «ميكي جيب»، «سوبرمان»، و«ملف المستقبل». كانت تضحك عندما أختار «ملف المستقبل» للمرة العاشرة، وتقول:
«هتحب الفضاء أكتر من الأرض، يا ولدي؟»
ولادة حب الخيال العلمي
كانت مجلات «ملف المستقبل» بوابتي إلى عالم آخر. كنتُ أقرأ عن السفر إلى المريخ، والروبوتات، والزمن المنحني، وأعود إلى أمي أسألها:
«هل ممكن نعيش على كوكب تاني؟»
فتجيب وهي تضحك:
«لو عشت معايا، نعيش على أي كوكب تحبه».
كانت تشتري لي كتبًا صغيرة عن الفضاء، وتجلس معي على السطح ليلًا، نشير إلى النجوم، ونخترع أسماء لكواكب لم تكتشف بعد. كانت تقول:
«شايف النجمة اللي بتلمع أوي دي؟ دي كوكبنا إحنا، اسمه (نور وولدها)».
وكنت أصدقها.
الدراسة: رفيقة النجاح
لم تكن أمي مجرد أم، بل كانت معلمة، ومدربة، وملهمة:
- في الابتدائية، كانت تجلس معي كل مساء على مكتب صغير في غرفة المعيشة، تحلّ معي مسائل الرياضيات، وتشرح لي قواعد النحو بطريقة تجعلني أحب اللغة العربية. كانت تكتب لي قصصًا قصيرة عن «فتى يسافر عبر الزمن» لأتعلم الإملاء.
- في الإعدادية، كانت تراجع معي الجبر والعلوم، وتستخدم مجلات «ملف المستقبل» لتشرح لي النظرية النسبية بطريقة بسيطة: «الزمن يمشي ببطء لو كنت بتحب اللي معاك».
- في الثانوية، كانت تصحّح لي بحوث التاريخ والجغرافيا، وتعلمني كيف أكتب مقالًا بأسلوب أدبي. كانت تقول:
«اكتب زي ما بتحس، مش زي ما بتحفظ».
لحظات الخصوصية
كانت تعتني بصحتي كأنني زجاجة عطر ثمينة:
- إذا مرضت، كانت تبقى بجانبي طول الليل، تضع كمادات باردة على جبيني، وتغني لي أغنية «يا ليل يا عين».
- كل عيد ميلاد، كانت تعدّ لي كعكة بنفسها، وتضع عليها شمعة واحدة كبيرة، وتقول: «السنة دي كلها ليك، يا حبيبي».
- في الشتاء، كانت تلفني بشالها الصوفي، ونشرب الشاي بالنعناع معًا، ونحكي عن أحلامنا.
أنا في العاشرة، وهي في الثانية والعشرين
كنا أقرب إلى أخوين من أم وابن. كانت ترتدي جينز وقميصًا قطنيًا، وتجري معي في الشارع لنلحق بالأتوبيس المدرسي. كانت تضحك عندما أناديها «نور» بدل «ماما» أمام أصحابي، وتقول:
«خلاص، أنا نور بتاعتك، وأنت بطل سوبرمان بتاعي».
كنت أشعر أن العالم كله يتسع لنا فقط، وأن السنوات العشر القادمة ستكون امتدادًا لهذا الحب الذي بدأ ينمو بيننا، حبًا لا يُسمّى بعد، لكنه كان يعيش في كل لمسة، وكل كلمة، وكل نظرة.
الفصل الخامس: ليلة الاكتشاف
كنتُ في الخامسة عشرة من عمري، في تلك السن التي يبدأ فيها الجسد يثور والعقل يتساءل عن كل شيء مخفي. كانت أمي، نور، في السابعة والعشرين، لا تزال تحتفظ بتلك الرشاقة والجمال الذي يجعلها تبدو كفتاة في العشرينيات، شعرها الأسود الطويل يتدفق كشلال، وعيناها العميقتان تخفيان أسرارًا أكبر من عالمي الصغير. أما أبي، حسن، فقد عاد إلى حياتنا بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، بعد غياب طويل، يعمل في ورشته الكبيرة الآن في المدينة، ويحاول أن يعوض عن الوقت الضائع. كنا نعيش في الشقة نفسها في الدقي، لكن الجو أصبح أكثر توترًا، أكثر دفءًا، كأن الجدران تحتفظ بأسرار لا أفهمها بعد.
كانت ليلة صيفية حارة، من تلك الليالي التي يصعب فيها النوم، والرطوبة تلتصق بالجلد كعاشق متعب. استيقظتُ في منتصف الليل عطشانًا، فخرجتُ من غرفتي بهدوء، متجهًا إلى المطبخ لأشرب كأس ماء. كانت أبواب المنزل مفتوحة جزئيًا بسبب الحر، وباب غرفة نوم والديّ مواربًا قليلاً، يتسلل منه ضوء خافت من مصباح السرير. سمعتُ أصواتًا خافتة، همسات، ضحكات مكتومة، فتوقفتُ عن الحركة، قلبي يدق بقوة. كنتُ أعلم أنني يجب أن أستمر في طريقي، لكن الفضول دفعني إلى الاقتراب، ألقي نظرة سريعة من خلال الفتحة الضيقة.
كانا عاريين تمامًا، حافيي القدمين على السجادة الناعمة، جسداهما يلمعان بعرق الصيف الخفيف. أمي كانت تجلس على حافة السرير، ساقاها متدليتان، قدماها الصغيرتان تلامسان الأرض، وأبي يقف أمامها، قضيبه المنتصب يبرز كرمح قوي أمام وجهها. كانت تتحدثان بصوت منخفض، حديث جنسي مثير مليئ بالدلال من جانبها، والتمنع الذي يزيد الرغبة اشتعالاً.
“يا حبيبي، مش عايزة دلوقتي… خليني أشبع من نظرتك الأول،” قالت أمي بصوت مدلل، عيناها تلمعان وهي ترفع يدها الناعمة لتمسك قضيبه بلطف، أصابعها تتجول عليه كأنها تعزف لحنًا سريًا. كانت تضحك بخفة، تضغط عليه قليلاً ثم تتركه، تمنعه وهي تبتسم. “شوف إزاي هو واقف زي الجندي… بس أنا لسه مش جاهزة، يا حسن. خليك صابر شوية.”
أبي كان يتنهد، يمرر يده في شعرها الطويل، “نور، يا بنت الإيه، أنتِ بتعذبيني… تعالي، خليني أذوقك.” لكنه كان يستسلم لدلالها، يقترب أكثر، قضيبه يلامس شفتيها الغليظتين المورقتين.
ثم بدأت أمي في تدليك قضيبه، يداها الناعمتان تتحركان صعودًا وهبوطًا ببطء، تضغطان بلطف على الرأس، ثم تنزلان إلى القاعدة، أصابعها تفرك الجلد المتوتر. كانت تئن بخفة، “آه، إيه الصلابة دي… زي الحديد، يا حبيبي.” أبي كان يغمض عينيه، يمسك رأسها بلطف، يدفعها نحوها.
فجأة، انحنت أمي، فتحت شفتيها، وأخذت قضيبه في فمها، تمصه ببطء، لسانها يدور حول الرأس، تمتصه كأنها تتذوق أشهى حلوى. كانت تخرجه من فمها أحيانًا، تلحسه من الأسفل إلى الأعلى، ثم تعيده داخل، صوت المص الرطب يملأ الغرفة. “ممم، طعمه حلو أوي… بس مش هخلص بسرعة،” قالت وهي ترفع عينيها إليه بدلال.
أبي لم يتحمل، دفعها بلطف لتستلقي على السرير، ثم انحنى بين ساقيها. رفع ساقيها قليلاً، وانزل وجهه إلى كسها الغليظ الشفاه، المورق المتهدل الرائع، تلك الشفاه اللحمية المتورمة من الرغبة، تتدلى كبتلات وردة مبللة. بدأ يلحسها بلسانه الطويل، يمررها على الشفاه الخارجية، يفصلها بلطف، ثم يمص البظر الصغير المنتصب. كانت أمي تئن بصوت عالٍ، “آه يا حسن… لحس أكتر، مص الشفايف دي… هي دي اللي بتحبك.” كان يداه تتدلكان نهديها الكبيرين، يعصران الحلمتين الداكنتين، يفركانهما بحنان عنيف، بينما لسانه يغوص داخل الكس، يلحس الجدران الداخلية، يمص العصارة التي تسيل.
ثم رفع ساقيها عاليًا على كتفيه، قضيبه يلامس مدخل كسها، وبدأ ينيكها في الوضع التبشيري، يدخل ببطء أولاً، ثم يزيد السرعة، جسده يصفع جسدها، نهداها يرتجان مع كل دفعة. “آه، يا نور… كسك ضيق زي أول مرة،” قال أبي وهو يغوص عميقًا.
لكن أمي دفعته فجأة، “خلاص، دوري أنا دلوقتي.” دفعته ليستلقي على الفراش، ثم جلست بكسها على قضيبه في وضع الفارسة، تواجهه، تصعد وتهبط ببطء، كسها يبتلع القضيب كاملاً ثم يخرجه، عصارتها تسيل على فخذيه. كانت تئن، “شوف إزاي بأركبك… زي الخيل الجامح.” نهداها يرتجان بعنف، يدا أبي تمسكان بهما، يعصرانهما.
ثم دارت، وضع الفارسة المعكوسة، تواجهني الآن من خلال الباب الموارب، ترى عينيّ من خلال الفتحة، وتبتسم ابتسامة عريضة، عيناها تلمعان بالدهشة والإثارة، وهي تصعد وتهبط بسرعة أكبر، كسها يبتلع القضيب ويخرجه، نهداها يرتجان كالموج، يدا أبي تمسكان بمؤخرتها المدورة، يدفعانها لأعلى ولأسفل. كانت تبتسم لي، كأنها تقول سرًا، بينما تئن بصوت أعلى، النشوة تقترب.
أخيرًا، استلقت أمي على جنبها الأيمن، جسدها المنحني كقوس ناعم، وخلفها أبي على جنبه، قدماه تعانقان قدميها الصغيرتين بحنان، أصابعهما تتشابك كأنهما في رقصة حميمة. دفع قضيبه مرارًا وتكرارًا، دخولاً وخروجًا في كسها في وضع جانبي مثير جدًا، كل دفعة تخترقها عميقًا، تصطدم بجدرانها الرطبة، صوت التصفيق اللحمي يتردد. عينا أمي لم تفارقاني، مثبتتان عليّ من خلال الفتحة، مليئتان بالرغبة والجرأة، وهي تدفع جسدها للخلف بقوة، تنهل بكسها من قضيب أبي أكثر وأكثر، كأنها تبتلعه كاملاً في كل حركة. آهاتها وآهاته تملآن الغرفة، “آه… أعمق، يا حسن… ملّيني…” وهو يزمجر، “نور… كسك بيحرقني…”
حتى صاح أبي أخيرًا، انتفض جسده عدة مرات بعنف، يفرغ داخلها نبضات قوية، ثم أخرج قضيبه ببطء. في تلك اللحظة، ظهر أمامي جمال شفاه كس أمي الغليظة المورقة، تنفرجان بلطف عن فطيرة قشدة كثيفة ووفيرة جدًا، بيضاء لزجة تنسال من مهبلها المنتفخ، هابطة ببطء على الملاءة تحتها، تترك خطوطًا لامعة كدليل على النشوة التي غمرتهما. كانت أمي لا تزال تنظر إليّ، تبتسم بخفة، عيناها تخفيان سرًا جديدًا، بينما أنا أقف متجمدًا، عالمي يتغير في تلك اللحظة إلى الأبد.
الفصل السادس: مواجهة الأم
بعد تلك الليلة، لم يعد شيء كما كان. كنتُ أتجنب عيني أمي في الصباح، أهرب إلى غرفتي بعد المدرسة، أدفن رأسي في كتب الخيال العلمي كأنها درع يحميني من الأفكار التي تطاردني. لكن أمي، نور، لم تكن من النوع الذي يترك الأمور معلقة. كانت تعرف أنني رأيتُ، وكانت تعرف أن الصمت سيقتلنا ببطء.
في مساء اليوم الثالث، طرقت باب غرفتي بلطف. كنتُ جالسًا على السرير، أحاول قراءة “ملف المستقبل” لكن الكلمات تهرب من عينيّ. دخلت دون انتظار إذن، مرتدية ثوب نوم قطني خفيف بلون الخوخ، شعرها مفكوك يتدفق على كتفيها، وفي يدها كوبان من الشاي بالنعناع.
“مش هتشرب معايا؟” قالت بهدوء، وهي تضع الكوبين على المنضدة الصغيرة. جلست بجانبي على حافة السرير، لمست كتفي بلطف. “ثلاث أيام ما بتكلمنيش غير بكلمتين. أنا عملت حاجة؟”
لم أستطع النظر إليها. “لا… بس أنا…” بدأتُ أتلعثم.
وضعت يدها تحت ذقني، رفعت وجهي بلطف حتى التقت عيناي بعينيها. كانتا هادئتين، عميقتين، لا حكم فيهما، لا خجل. “أنت شفتني مع بابا، صح؟”
تجمدتُ. شعرتُ بحرارة تصعد إلى وجهي. “أنا… كنت عطشان… الباب كان موارب…”
ابتسمت ابتسامة صغيرة، ليست ساخرة ولا محرجة. “وكنت واقف بره كتير؟”
لم أرد. لم أستطع.
مسحت خصلة شعر من جبيني. “اسمع يا حبيبي. أنا أمك، وأنا كمان إنسانة. وليا جسم، وليا رغبات، وليا حياة مع جوزي. اللي شفته ده… جزء من الحياة. مش عيب، ومش خطأ. بس أنا عارفة إنك لسه صغير، وإن الموضوع ده كبير عليك.”
حاولتُ التحدث، لكن صوتي خرج خافتًا: “أنا… شفتك وأنتِ… بتضحكي، وبتبصي لي… وكنتِ مبسوطة…”
توقفت لحظة، ثم تنهدت بعمق. “أيوه، شفتك. وما اتخضيت. لأني عارفة إنك مش *** صغير أوي دلوقتي. وكنتِ عايزة أعرف إن اللي بيني وبين باباك ده حب، ومتعة، وثقة. مش سر، ومش حاجة نخبيها زي المجرمين.”
نظرتُ إليها بدهشة. “يعني… مش زعلانة مني؟”
“زعلانة؟” ضحكت بخفة، صوتها كالجرس. “أنا فخورة بيك. إنك ما هربتش، إنك ما كدبتش، إنك جيت قدامي دلوقتي وبتسأل. ده يعني إنك راجل بجد.”
اقتربت أكثر، وضعت ذراعها حول كتفيّ. “بس أنا عايزة أحكيلك حاجة. اللي شفته ده… ده بين اتنين بيحبوا بعض. وأنت لسه ما وصلتش للمرحلة دي. ولو حابب تسأل، أو تفهم، أو حتى لو خايف… أنا هنا. دايمًا.”
ثم اقتربت أكثر، همست في أذني بصوتٍ ناعمٍ وواثق: “وكلما حبيت تفرج علينا، فقد رأيت إن ذلك يمتعك ويسعدك، حتى وإن كان يصدمك ويخيفك، لكنه أيضًا يمتعك.” وفي لحظةٍ لم أتوقعها، حركت يدها بسرعة على قضيبي من فوق البنطلون، ضغطة خفيفة سريعة، كأنها تؤكد كلامها، ثم ابتعدت فورًا، عيناها تلمعان بمزيج من الحنان والجرأة.
ساد صمت دافئ بيننا. ثم همست: “بس المرة الجاية، لو عطشان، خبط على الباب الأول، ماشي؟”
ضحكتُ رغمًا عني، وهي ضحكت معي. في تلك اللحظة، شعرتُ أن شيئًا كبيرًا انكسر بيننا… لكن شيئًا أجمل بُني مكانه. ثقة. صراحة. حب لا يخجل من الحقيقة.
في الليل، نمتُ وأنا أسمع صوتها في المطبخ، تعد الفطار للغد، وأبي يغني أغنية قديمة بصوت منخفض. وفجأة، شعرتُ أن البيت أكبر، وأنا أكبر، وأن العالم الذي كنتُ أخاف منه… هو في الحقيقة مجرد حياة، مليئة بالدفء، والأسرار، والحب.
الفصل السابع: نار السرّ المكشوف
مرت أسابيع قليلة بعد “المواجهة”، لكن الهواء في البيت تغيّر. أصبحت نظرات أمي تحمل ابتسامة خفية كلما مررتُ بها في الممر، وأبي يربت على كتفي بقوة أكبر من المعتاد، كأننا نشارك سرًّا لا يُنطق. أما أنا، فكنتُ أحمل في صدري لهيبًا لا ينطفئ: صور تلك الليلة، وكلماتها، ولمستها السريعة التي لا تزال تحرق بنطلوني كلما تذكرتها.
في ليلة جمعة، كان الحرّ شديدًا، والمنزل هادئًا إلا من صوت مكيف قديم يزقزق في غرفة المعيشة. قالت أمي إنها ستأخذ دشًا طويلًا، وأبي تبعها بعد دقائق بكلمات هامسة لم أسمعها. أطفأتُ نور غرفتي، ومشيتُ حافيًا في الظلام حتى وصلتُ إلى باب غرفتهما. كان مواربًا أكثر هذه المرة، كأن الدعوة مفتوحة. دخلتُ رائحة زيت اللوز المحمّص، وسمعتُ صوت قطرات الماء لا تزال تتساقط في الحمّام المجاور.
دخلتُ الغرفة بخطوات خفيفة، وقفتُ خلف ستارة الخزانة الزجاجية التي تعكس السرير كمرآة. كانا عاريين، جلد أمي لامع من الزيت، وأبي يجلس على ركبتيه خلفها، يفرك كفه بكمية وفيرة من “كيه واي” الشفاف. أخرجتُ أنفاسي ببطء، قلبي يخفق كطبل حرب.
1. التحضير: طقوس الزيت والترقّب
أمي مستلقية على بطنها، وسادتين تحت حوضها، ترفع مؤخرتها كقوس ممتلئ. أبي يصبّ الجلّ ببطء على فتحة طيزها الوردية الصغيرة، يدور بإصبعه السبابة حول الحلقة الضيقة، يضغط بلطف حتى يغوص الإصبع الأول، ثم الثاني، يوسّع ببطء وهي تئن: “آه… يا حسن… برد، بس حلو… دخّل أكتر…” كان يهمس: “هنعملها زي ما بتحبي، يا نور… طيزك دي ملكي الليلة.” ثم صبّ الجلّ على قضيبه المنتصب، يفركه بكفه حتى يلمع كسيف مزيت، الرأس الأرجواني يبرز من بين أصابعه.
2. الوضع التبشيري الشرجي: الغوص الأول
استلقت أمي على ظهرها، ركبتاها مرفوعتان إلى صدرها، قدماها الصغيرتان في الهواء. أبي يضع رأس قضيبه على الفتحة، يدفع ببطء شديد. رأيتُ الحلقة الوردية تتمدد، تبتلع الرأس، ثم الجذع ببطء مؤلم وممتع. أمي تعضّ شفتها السفلى، عيناها مثبتتان عليّ من خلال انعكاس الزجاج، تبتسم ابتسامة ناعمة وهي تئن: “آه… دخل كله… شوف يا حبيبي إزاي طيزي بتاكل زبه…” أبي يبدأ بالدفع البطيء، كل دخول يخرج معه لمعان الجلّ، ثم يعود أعمق. صوت التصفيق اللحمي يبدأ خافتًا، يعلو تدريجيًا.
3. الفارسة: سيطرة الأم
قامت أمي، دفعت أبي على ظهره، جلست فوق قضيبه ببطء، تتحكم في العمق. طيزها تنزل حتى يختفي القضيب كاملاً، ثم ترتفع حتى يبقى الرأس فقط داخلها. كانت تتحرك بحركات دائرية، نهداها يهتزان كالموج، عيناها لا تفارقاني: “شايف يا ولدي؟… طيز ماما بترقص على زب بابا…” أبي يمسك خصرها، يدفع لأعلى، يزمجر من المتعة.
4. الفارسة المعكوسة: العرض المباشر
دارت أمي، ظهرها لأبي، تواجهني تمامًا. رأيتُ طيزها الممتلئة تنفتح وتغلق على القضيب، الجلّ يسيل على فخذي أبي. كانت تصعد وتهبط بسرعة متزايدة، صوت التصفيق يرج الغرفة، وهي تمد يدها للخلف تمسك كيس أبي، تدلكه بلطف. عيناها في عينيّ، تبتسم وكأنها تقول: “متّع نفسك، يا حبيبي.”
5. الوضع الكلبي: العمق الوحشي
انقلبت أمي على أربع، رأسها على الوسادة، مؤخرتها مرفوعة. أبي يدخل من الخلف بعنف، يمسك خصرها بكلتا يديه، يدفع بقوة حتى تصطدم خصيتاه بكسها. كل دفعة تخترقها حتى القاعدة، طيزها ترتجّ، نهداها يتأرجحان تحتها. كانت تصرخ بصوت مكتوم: “أيوه… نيك طيزي… أعمق… خلّيها تحسّ بيك كلّه…”
6. الوضع الجانبي: الختام الحميم
استلقت أمي على جنبها الأيسر، ساقها العلوية مرفوعة بيد أبي. دخل من الخلف في وضع ملعقة، قضيبه يغوص في طيزها بزاوية جديدة. كان يدفع ببطء عميق، يدور داخلها، يداه تتدلكان نهديها من الخلف. عيناها لا تفارقاني، تبتسم، تئن: “شايف إزاي طيزي بتاكل زبه من الجنب كمان؟…”
7. الجرأة: أنا والمتعة المكشوفة
لم أعد أتحمل. يديّ ترتجفان، لكن شيئًا بداخلي انفجر. فتحتُ سحّاب بنطالي، أخرجتُ قضيبي المنتصب بقوة، أمسكته بيدي، أدلكه ببطء أمام عينيها. توقفت أمي لحظة، عيناها تلمعان بدهشة وموافقة، ثم ابتسمت ابتسامة عريضة، همست بصوت يقطع الهواء: “أيوه كده… دلّعه قدام ماما… خلّيني أشوفك وأنت بتستمتع…” واصلتُ، يدي تتحرك بسرعة متزايدة، عيناي على طيزها وهي تبتلع قضيب أبي، صوت آهاتها يرج الجدران.
8. الذروة: عاصفة مشتركة
أبي زاد سرعته في الوضع الجانبي، يدفع بعنف، يزمجر: “هجيب… جوا طيزك…” أمي تصرخ: “أيوه… ملّيها…” انتفض أبي، قضيبه ينبض داخلها، يفرغ حمولته الساخنة. في اللحظة نفسها، شعرتُ بجسدي يرتجف، أطلقتُ نبضاتي على يدي، أمام عينيها، وهي تبتسم وتنظر إليّ بنظرة أم وصديقة وعشيقة في آن.
سحب أبي قضيبه ببطء، فتحة طيز أمي مفتوحة قليلاً، تخرج منها قطرات بيضاء كثيفة تسيل على فخذها. نهضت أمي، اقتربت مني بخطوات هادئة، مسحت يدي بمنديل ناعم، همست: “كفاية لليلة دي… بس لو حابب تاني… الباب هيفضل موارب.” ثم قبلت جبيني، وتركتني في الظلام، قلبي يدق، وجسدي يرتجف من متعة لم أعرفها من قبل.
الفصل الثامن: ميلاد الرغبة، وتفتّح الروح
كان اكتشافي للجنس أول مرة في حياتي، ليس في صفحة كتاب أو شاشة سرية، بل في حضن أهم إنسانة في وجودي: أمي، نور. هي التي أطعمتني ألذ الأطعمة بيديها الناعمتين، تلك الفطائر المحشوة بالجبنة والزعتر، والملوخية الخضراء اللامعة، والكوسا المحشي الذي كان يذوب في الفم كحلم. هي التي أنعمت عليّ بكل نعمة: سرير دافئ، ملابس مطرزة بأزرار لامعة، كتب «ملف المستقبل» التي اشترتها لي قبل أن أطلبها. هي التي ثقفتني في كل مجال: قرأت لي شعر أمل دنقل وأنا في العاشرة، شرحت لي نظرية أينشتاين بأمثلة من حياتنا، علّمتني كيف أكتب مقالاً أدبياً يشبه مقالات توفيق الحكيم.
قبل تلك الليلتين، لم أكن أشتهيها بالمعنى الجنسي. كنتُ أراها عظيمة، هائلة، كأنها تمثال من نور. كنتُ أحبها حبًا يملأ صدري، لكنني لم أكن أعرف اسمه. كنتُ أشعر بجاذبية غريبة كلما مررتُ بجانبها: رائحة شعرها بعد الاستحمام، دفء ذراعها حين تضع رأسي على فخذها، صوت ضحكتها الذي يشبه نغمة فيروز. لكنني لم أكن أعرف أن هذا الشعور يمكن أن يتسع ليصبح رغبة.
ثم جاءت الليلتان. الأولى في الوضع التبشيري والفارسة، والثانية في طيزها المزيتة بـ«كيه واي». رأيتُ جسدها يتحرك، يئن، يبتلع، يمنح، يأخذ. سمعتُ أبي يزمجر اسمها كأنه يصلي. وسمعتُها تهمس لي من بعيد: «متّع نفسك، يا حبيبي». ثم جاءت إجاباتها على أسئلتي في اليوم التالي: شرحت لي البظر والمهبل والشرج بكلمات هادئة، كأنها تشرح درسًا في الجغرافيا. قالت: «الجنس مش عيب، يا ولدي. هو لغة حب، زي الشعر، زي الموسيقى». أشبعت فضولي، لكنها أشعلت فيّ نارًا جديدة.
بدأتُ أكتب في كشكولي الأسود ذي الغلاف الجلدي. كنتُ أكتب بالليل، تحت ضوء مصباح خافت، بخط يرتجف:
«اليوم الثلاثاء، ١٧ أكتوبر. رأيتُ ماما عارية. طيزها كالقمر، لكن أكثر دفئًا. لماذا أشعر أنني أريد أن ألمسها؟ هل هذا حب؟ أم مرض؟»
ثم:
«الخميس. سألتها عن النشوة. قالت: “هي زي ما تكون في الفضاء، والأرض تدور تحتك”. ابتسمت لي. لم تنهرني. قالت: “كبر براحتك، يا حبيبي. أنا هنا”.»
لم تُوبّخني يومًا. كانت تلاحظ انتصابي الصباحي حين أجلس بجانبها على الأريكة، فتبتسم ابتسامة جانبية، تضع يدها على ركبتي، وتغيّر الموضوع إلى فيلم قديم. كانت تزرع فيّ الرغبة، لكن ببطء، كأنها تروي نبتة صغيرة.
استمر الأمر سنوات. بلغتُ الثامنة عشرة، وأصبحتُ طقوسنا أكثر حميمية. كل جمعة مساءً، أجلس خلفها على الأرض، أمشّط شعرها الطويل بفرشاة خشبية، أمرر أصابعي بين خصلاته، أشم رائحة زيت الأرغان. ثم أطلي أظافرها: أحمر قانٍ في الأعياد، أرجواني في الشتاء. أضع لها أقراطها الذهبية الصغيرة، أربط عقدها حول عنقها، أضع خلخالها الفضي حول كاحلها، وأقبّل قدمها بخفة كل مرة. كانت تغمض عينيها، تتنهد، تقول: «أنت أحسن مصمم في الدنيا، يا ولدي».
في الخفاء، كنتُ أغوص في عالم الإنترنت. قرأتُ قصص «جنس محارم» عربية وإنجليزية، شاهدتُ أفلام بورنو تتحدث عن الأمهات والأبناء. لم أكن أبحث عن الإثارة فقط، بل عن التفسير. هل أنا مريض؟ هل هذا طبيعي؟ وجدتُ منتديات تتحدث عن «الافتتان الأوديبي»، عن «الجاذبية الأولية». كنتُ أقرأ، أكتب ملاحظات، أحلل نفسي كأنني عالم نفس.
أمي لم تكن غافلة. كانت تراقبني كأم وكصديقة. في إحدى الليالي، دخلتْ غرفتي فجأة، وجدتني أقرأ قصة بعنوان «أمي وأنا في ليلة المطر». لم تغضب. جلست بجانبي، قرأت السطر الأول، ثم قالت: «القصص دي حلوة، بس الحقيقة أحلى. لو عايز تعيش حاجة، خلّيني أختارلك شريكة حقيقية، مش خيال».
بدأت خطتها السرية. دعتني لزيارة الجيران:
- السيدة ليلى، أرملة في الخامسة والثلاثين، جارتنا في الدور الثاني. طويلة، بشرتها قمحية، تضحك بصوت عالٍ. أمي قالت لها: «ابني عايز يتعلم يصلّح الكمبيوتر، ممكن يجي يساعدك؟» ذهبتُ، جلستُ بجانبها، لمستُ يدها وهي تشرح لي مشكلة في الجهاز. شعرتُ بأول قبلة حقيقية في حياتي، في مطبخها، بينما أمي تنتظرني في الخارج.
- الآنسة منى، مطلقة، تعمل مدرسة فرنساوي. أمي رتبت لي درس خصوصي في الفرنسية. كانت ترتدي تنورة قصيرة، تضع رجلها على رجلي تحت الطاولة. في الدرس الثالث، قبلتني في عنقي، همست: «أمك قالتلي إنك ذكي جدًا… ووسيم كمان».
- السيدة سحر، أرملة أخرى، تملك مكتبة صغيرة. أمي أرسلتني لأساعدها في ترتيب الكتب. كانت تضع نظارتها، شعرها مربوط، ثم فجأة فكته، قالت: «أنت تشبه بطل رواية أحبها». في اليوم التالي، أغلقت المكتبة، أغلقت الباب، وعلّمتني كيف تُقبّل امرأة بلسانها.
كنتُ أعود إلى البيت، أروي لأمي كل شيء. لم تكن تغار. كانت تسأل: «حسّيت إيه؟ عجبك؟» ثم تضيف: «كويس، جرب، تعلم، بس احتفظلي بقلبك». كانت تدرّبني على الحب كما درّبتني على القراءة، خطوة بخطوة، دون استعجال.
في كشكولي، كتبتُ في النهاية:
«اليوم، ٢٩ أكتوبر. أنا في الثامنة عشرة. ماما هي أول امرأة أحببتها، وهي من علّمتني كيف أحب النساء. لم تمسسني يومًا بيد جنسية، لكنها فتحت لي أبواب الدنيا. أنا الآن أعرف: الحب ليس خطيئة، والرغبة ليست عيبًا. هي فقط لغة، وماما هي أستاذتي الأولى».
وفي تلك الليلة، جلستُ خلفها كالعادة، أمشّط شعرها، أطلي أظافرها بالأرجواني، أضع خلخالها. نظرتْ إليّ في المرآة، قالت: «كبرت، يا ولدي. دلوقتي دورك تختار. أنا هفضل دايمًا هنا، بس العالم كبير». ابتسمتُ، قبلتُ جبينها، وشعرتُ أنني أصبحتُ رجلاً، بفضل امرأة لم تمسسني يومًا، لكنها امتلكتني كلّي، بالحب، بالثقة، بالحرية.
الفصل التاسع: موسوعة الرغبة، وتوزيع اللهيب
لم يكن بحثي في عالم الإباحة مجرد إشباع فضول، بل كان مشروع تثقيف شامل، كأنني أعدّ رسالة دكتوراه في «علم الجنس البشري». كنتُ أقضي ساعات الليل أمام شاشة الكمبيوتر، أفتح عشرات التبويبات، أقرأ، أشاهد، أكتب ملاحظات في كشكولي الأسود. لم أقتصر على فئة واحدة؛ كنتُ أريد أن أفهم كل شيء، كأنني أرسم خريطة لكل أنواع الرغبة البشرية.
1. المحارم: جذور الافتتان
بدأتُ بالمحارم، لأنها كانت أقرب إلى قلبي. قرأتُ قصص الأمهات والأبناء، ثم توسعتُ:
- الآباء والبنات: قصص عن أب يعلّم ابنته «درس الحياة» في ليلة عيد ميلادها الثامن عشر.
- الإخوة: أخ وأخت يتقاسمان السرير في رحلة عائلية.
- الأعمام والخالات: عم يزور ابنة أخته في الجامعة.
- محارم الصهر: زوج الأم مع ابنتها من زوج سابق.
- محارم الرضاعة: أخ وأخت رضعا من ثدي واحد.
كنتُ أقارن كل قصة بما أعيشه مع أمي. أكتب في الكشكول: «هل لو كانت أمي رضعتني أكثر، لكانت رغبتي أقوى؟».
2. التحرر الزوجي والدياثة
انتقلتُ إلى الدياثة: أزواج يشاهدون زوجاتهم مع رجال آخرين. وجدتُ منتديات عربية كاملة لهذا، قصص عن أزواج يصورون زوجاتهم في فنادق. كنتُ أتخيل أمي في هذا الدور، ثم أهز رأسي بسرعة: «لا، هي ملكي».
3. المثلية والتنوع
- المثلية الذكرية: أفلام عن شابين في صالة رياضية.
- المثلية الأنثوية: فتاتان في حفلة جامعية. كنتُ أشاهد لأفهم، لا لأشتهي. كتبتُ: «الجنس لا يعرف جنسًا، فقط رغبة».
4. الخيال العلمي والرعب والفانتازيا
- خيال علمي جنسي: كائنات فضائية تمتلك أعضاء متعددة.
- رعب جنسي: أشباح تمارس الجنس في قصر مهجور.
- فانتازيا: جنيات وتنانين وأعضاء سحرية.
كنتُ أمزج بين عالمي القديم (مجلات «ملف المستقبل») وعالمي الجديد.
5. الفض البكارة والمرات الأولى
قرأتُ قصص فض البكارة للفتيات والفتيان، سواء بالتراضي أو بالقوة. كنتُ أتخيل نفسي في كلا الدورين، ثم أشعر بالذنب.
6. الألعاب والفتشيات
- الشيميل: رجال بأثداء وأعضاء أنثوية.
- السادية والمازوخية: جلد، شمع، تقييد.
- البارافيليا: قدم، ملابس داخلية، رائحة.
- جنس الطمث: قصص عن الحيض كجزء من المتعة.
كنتُ أجرب بعضها سرًا: أشم جوارب أمي، أتخيل تقييدها.
7. المشاهير والعرقيات
- مشاهير: قصص عن ممثلات عربيات ومغنيات، أو مقدمات برامج.
- الإنتراشيال: أسود مع بيضاء، صيني مع أوروبية، هندي مع عربية.
8. الجماعي والشرجي والاستعراضية
- جانج بانج وأورجي: مجموعات في حفلات.
- إيلاج مزدوج: مهبل وشرج معًا.
- جنس شرجي: قصص تفصيلية عن التحضير بـ«كيه واي».
- استعراضية: مشاهدة وممارسة أمام الآخرين.
9. الابتزاز والقوة والترانسفستايت
- جنس بالقوة: قصص ****** (كنتُ أشعر بالاشمئزاز، لكنني أكملتُ لأفهم).
- ترانسفستايت: رجال يرتدون فساتين، نساء بدلات.
كنتُ أكتب في الكشكول: «الجنس بحر، وأنا أسبح في كل تيار».
10. توزيع الرغبة: النسوة الثلاث
لكن الواقع بدأ يتدخل. النسوة الثلاث التي اختارتهن أمي أصبحنَ محطات حقيقية:
- ليلى: بشرتها قمحية، نهداها كبيران، تضحك بصوت عالٍ. كانت تعلمني الجنس الفموي في مطبخها، بينما رائحة الكسكس تملأ المكان. كنتُ أعود إلى البيت وأكتب: «ليلى مثل النار، لكن أمي هي الشمس».
- منى: المعلمة الفرنسية، نحيفة، سيقان طويلة. كانت تربط يديّ بحزام تنورتها، تعلمني التقبيل البطيء. كنتُ أهمس لها اسم أمي في النشوة، فتضحك: «أمك علّمتني إزاي أعلمك».
- سحر: صاحبة المكتبة، ذات النظارات، شعرها أسود طويل. كانت تقرأ لي قصائد نزار ونحن عرايا بين الكتب. كانت أول من دخلتُ شرجها، بإصبعي أولاً، ثم بقضيبي. كتبتُ: «سحر مثل الكتاب، أمي هي المكتبة».
كل واحدة منهن كانت مرآة لرغبة مختلفة، لكنهن جميعًا كن يخففن من حدة رغبتي في أمي. لم تعد أمي الوحيدة في خيالي. أصبحتُ أوزع لهيبي بينهن، كأنني أرسم لوحة بألوان متعددة، لكن أمي ظلت اللون الأساسي.
في إحدى الليالي، جلستُ مع أمي على الأريكة، رأسي على فخذها كالعادة. قالت: «شايف إزاي الدنيا كبيرة؟ كنت عايزة أعلمك إن الحب مش حاجة واحدة. ممكن تحبيني، وتحب ليلى، ومنى، وسحر… وغيرهم كمان. المهم تحترم، وتستمتع، وتتعلم».
نظرتُ إليها، قلتُ: «أنا لسه بحبك أكتر». ابتسمت، قبلت جبيني، وقالت: «وأنا كمان. بس الحب الكبير بيسيب مكان لغيره. ده سرّ السعادة».
وفي تلك اللحظة، أدركتُ أن رغبتي في أمي لم تختفِ، بل تطورت. أصبحت رغبة ناضجة، تحترم الحدود، توزع اللهيب، وتبقي أمي في القلب كأول وأعظم حب، لكن ليس الوحيد.